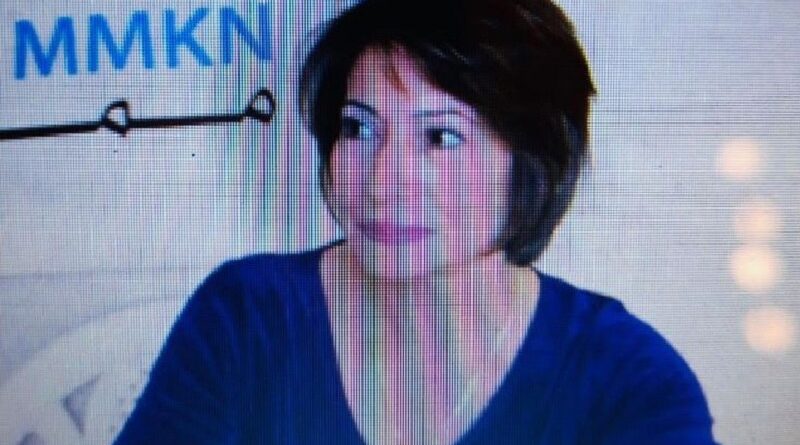ذاكرة الأماكن..من كتابي تراتيل عشق – حنان بكير
ذاكرة الأماكن..من كتابي تراتيل عشق
الناس هم روح المكان. هذا ما كتبته قبل سنواتٍ طويلةٍ. لاحقاً أيقنت أنّ الأمكنة تعرف أصحابها. ربّما تغيّر رأيي قليلاً، أو تأرجح ما بين البينَيْن.
في بيروت، قرّرت زيارة أوّل بيتٍ استأجره والدي بعد نكبة الـ 1948، وكانت لي فيه نشأة طفولةٍ سعيدةٍ. حيّ المنشيّة في برج البراجنة، شارع حاطوم. طريق فرعي، مزروعٌ ببيوتٍ تزيّن واجهاتها حدائقُ جميلةٌ، بعض شجرات نخيلٍ تنتصب بكبرياءٍ على بقيّة الأشجار، وشجرات زنزلخت نلعب في ظلالها كنت أشتمّ رائحة زهرها الصّغير الناعم، فيما يصرّ الجميع على أن لا رائحة لزهر الزنزلخت. أشجار الصبار ورغم قسوتها ومهابتها، كانت تغرينا بقطف الثمرات الناضجة.
كان البيت المؤلّف من غرفتَيْ نومٍ وغرفة استقبالٍ، تحيط به حديقةٌ، أذكر الزنبق والبنفسج من زهورها، كنت أحبّ البنفسجَ، أمّا الزنبق الأبيض، فلم أكن أشعر بانتمائه لفصيلة الزهور، وإلى جانب البيت بستان برتقالٍ، وخلفه شجرة توتٍ، ومن جهته الأخرى بيت المالك أبو فؤاد حاطوم، الذي علّق رفوفاً خشبيّةً عريضةً، في مدخل درج البيت، وفرشها بورق التوت الأخضر، لتربية دود القزّ. كان يسمح لنا بتسلق شجرات التوت ومساعدته في قطفها. لكنه
لم يكن يسمح لنا بالاقتراب من دود القز، ويسمح لي من حينٍ لآخر، بإلقاء نظرةٍ عليها من مسافةٍ قريبةٍ، تقديراً لجهودي في جمع أكبر كميّةٍ من ورق التوت، ويناديني طرزان.
وفي هذا الحيّ أدركنا فوارق اللّهجتين الفلسطينيّة واللبنانيّة. هم يقولون هكذا، بينما نحن نلفظها كذا.
.. وهنا فتحنا عيوننا على لقب “لاجئ فلسطينيّ”، كان صبيان هذا الحيّ أكثر شقاوةً من بناته، وكنت أنتمي الى شقاوة الصبيان. كان يبهرنا الرجل الذي يتسلّق النخلة العالية لقطف ثمارها الناضجة، يحيط نفسه والشجرة بحبلٍ سميكٍ، يتسلّق بضع عُقَدٍ من الشجرة، يتوقّف قليلاً ليرفع الحبل بضع عقدٍ مماثلةٍ. ثمّ يقوم صاحب النخلة بتوزيع الثمار على سكّان الحيّ. تقول له جدّتي: “ثمر الدار بطوّل الأعمار”. حاولت ذات مرّةٍ تسلُّق النخلة باستعمال حبل غسيل سطوت عليه.
ما زلت أذكر معظم سكّان الحيّ، وإن سقطت من ذاكرتي بعض الأسماء والوجوه. ثلاث عائلاتٍ فلسطينيّةٍ، سكنت هذا الحيّ. نحن وبيت روبين وعائلة الدباح، وجميعنا من عكّا. وعلى مقربةٍ من مدخل الحيّ سكنت عائلتَيّ أبو رقبة، وحبيشي العكّاويّتين.
في كلِّ مرّةٍ أمرُّ من أمام الحيّ، ولا أرغب في رؤيته من الداخل، رعباً من صدمة التغيير، وحبّاً بالاحتفاظ بالذاكرة القديمة، مكاناً وسكّاناً… أردت أن أُبقيَ الحيّ كما هو، بكباره وصغاره الذين لم يكبروا، وأطفاله الذين ما زالوا يرضعون الحليب، وديدان القزّ التي لم تبن بعدُ شرانقها.
لكن هذه المرّة، قرّرت المغامرة مع شقيقتي، البيوت على الصّفّين صارت أبنيةً شاهقةً، وبعضها على غير ترتيبٍ وخالٍ من الأناقة. وصلنا الى نهايته، حيث كان يتصدّر بيتنا وبيت صاحب الملك، حافظ البيت الكبير على ملامحه العامّة، ورغم الهرم إلاّ أنّه حافظ على مهابة العمر. استوقفني أنّ الزجاج الملوّن في أعلى الباب المرتفع قد صار زجاجاً عاديّاً، ليس من باب الذكاء، إدراك تكسّر الزجاج الملوّن خلال قصف الحروب التي مرّت على المنطقة. أمّا مكان بيتنا، فقد قامت بنايةٌ صغيرةٌ، غير أنيقةٍ. اندثر بستان البرتقال، ولا أثر للبنفسج والزنبق، الزنبق الذي صرت أحبّه عندما استوطن الذاكرة، وصارت رؤيته تثير الحنين إلى ركنٍ ما في الذاكرة. لا نخل ولا زنزلخت.. ولا أثر لعرقٍ أخضرَ. حيٌّ حجريٌّ متصحّرٌ.
إلى يمين البيت الكبير، بدت واحةٌ خضراءُ نديّةٌ، تعبق برائحة الغاردينيا. بيتٌ وحديقةٌ واسعةٌ بأشجار فاكهةٍ مختلفةٍ، وأزهارٍ متنوّعةٍ.. مشهدٌ يرطّب هواءً صحراويًاً يلفح الذاكرة.. حاولنا تذكُّر المكان القديم لهذه الْجنة الصغيرة، فلم نفلح.
تناهى إلى سمعي صوتٌ يناديني باسمي. ترى من الذي يعرفني في هذا المكان الغريب؟! كان وجهاً سمحاً لامرأةٍ وقفت تحدّق بي بدهشةٍ.. تأمّلنا بعضنا بشيءٍ من الريبة.. ثوانٍ وصرخنا بأسماء بعضنا وتعانقنا.. ليس الحنين وحده من استيقظ وأيقظ عمراً سحيقاً.. يوم كنّا في طفولةٍ مبكّرةٍ.. لكنّ الحياة دبّت في عروق الحيّ كلّه.. وانثالت الذكريات والأحداث والأسماء، وأيقظنا جميع موتانا واستحضرناهم، بصورهم وصفاتهم.. شخصٌ واحدٌ من الذاكرة أحيا حيّاً بأكمله!
– كاتبة فلسطينية مقيمة في اوسلو