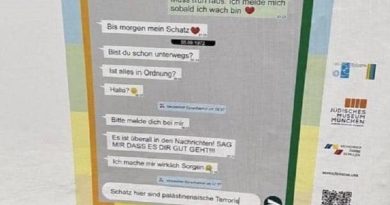الروائي الدكتور حسن حميد في حوار شيق – حوار – بسام جميدة
حوار مع قامة أدبية باسقة
الروائي الدكتور حسن حميد في حوار شيق أجريته معه لصحيفة عُمان العمانية
إليكم نص الحوار لمن يود القراءة:
د. حسن حميد: الكتابة حقل للقلق والمخاوف وأي نص أدبي لا يوفر المتعة هو نص شكاء
24 ديسمبر 2022
حوار – بسام جميدة
جعل الأسئلة موقدة النار التي شوى عليها نصوصه
سوريا تدفع ثمن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية لهذا خُربت –
لا أحد يجرؤ على ترجمة الأدب الفلسطيني إلى اللغات العالمية لأنه سيفضح المحتل!
لم يتنكر الكاتب الفلسطيني الدكتور حسن حميد لسوريا التي احتضنته وعاش فيها وبادلها الحب بالحب، وهو الذي شغل ذات يوم منصب نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب.
أخلص لقضيته الفلسطينية وكتب لها الكثير من الشعر والروايات والقصص، حتى لقب بأديب المخيمات. كاتب يتفرد بكتاباته السردية الممتعة التي يغلب عليها الهم الوطني ولا تخلو من الشعرية الممزوجة بالتشويق والتاريخ والرمزية والتي يحاول من خلالها جاهدًا أن يشير للتراب والتراث والتاريخ الفلسطيني، دون أن ينسى سوريا التي عاش على ترابها فكتب لها ونهل من تفاصيلها بكل ما يحمله من شغف الكتابة.. في المساحة التالية نقترب من الدكتور حسن حميد في هذا الحوار..
- هل أتحدت معك باسم الروائي الفلسطيني حسن حميد، أم الأديب والكاتب السوري الذي شغل يومًا ما منصب نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، أم في كلا الصفتين، لأديب قدم لنا رؤيته الأدبية من خلال السرد الكثير..؟
- أنا كاتب فلسطيني من الجليل الفلسطيني من قرية كراد البقارة المجاورة لجسر بنات يعقوب على نهر الأردن حين طُردت أسرتي مع أُسر القرية كلّها، فلجأنا إلى سوريا، وعشنا في إحدى القرى السورية القريبة من نهر الأردن واسمها (نعران) كانت مقامة على مرتفع عالٍ يطلّ على قريتنا، لهذا كان أهلي يقولون لقريتنا في الصباح، وهم ينظرون إلى بيوتها: صباح الخير، وقبل غياب الشمس: مساء الخير، وهم يبكون في الصباح والمساء.
بعد نكسة عام 1967 طُردنا مع الكثيرين من الجولان وجئنا لنعيش في أحد المخيمات الفلسطينية الواقعة في ضاحية دمشق الجنوبية، وقد درستُ وتعلمتُ وتثقفت وكتبت في سوريا، لذلك يظنّ الكثير من القراء إنني كاتب سوري. وقد وصلت إلى مكانة قيادية في اتحاد الكتاب العرب في سورية لأن زملائي انتخبوني، ولأن الاتحاد يضم عددًا كبيرًا من الأدباء العرب وأنا منهم.
أنا كاتب مهموم بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لهذا أوقفت الكثير من كتاباتي على معالجة جوانب من هذه القضايا، وجميعها للأسف موجعة، ومقلقة للتفكير، ومثيرة للأسئلة الثقيلة، وفي مقدمتها، لماذا يتقدم الآخرون ونحن نراوح في مكاننا، ولماذا نحن في مرمى نيران وأحقاد وأحلام الآخرين..؟ وهل النعم التي عرفتها بلادنا أو الخيرات التي حظينا بها هي لعنة..؟ ولماذا صار للضعف العربي تاريخ مرّ ووجيع، ثم ومن ناحية أخرى لماذا كلّ الأمكنة والأوطان والشعوب نالت استقلالها وعرفت تحررها من ربقة الاستعمار ما عدا البلاد الفلسطينية، فهل هذا الأمر لعنة أيضا..!
ولأن الأديب معني بالأسئلة فقد جعلت الأسئلة موقدة النار التي شويت عليها نصوصي منذ أن بدأت الكتابة وحتى هذه الساعة. - غالبية الروائيين يبدأون حياتهم الأدبية بالشعر، ومن ثم يكملون بالرواية، هل أصبح الولوج إلى باب القص الروائي مفتاحه الشعر، وما تأثيره في كتاباتك..؟
- بدأت كتابة الشعر في سنّ صغيرة، وعُرفت بأنني شاعر المخيم الصغير الذي عشت فيه «مخيم جرمانا» لأنني كنتُ أقرأ قصيدي في المقابر حين كانت تأتيها التوابيتُ بأجساد الشهداء البررة، وكان لا بدّ من الشعر في مقبره الشهداء كي يخفت صوت بكاء الأمهات، وكي تعود الطيور إلى الأشجار المحيطة بالمقبرة، وكي تتعالى سقسقة السّاقية الجارية قرب المقبرة.
وقد ودّعت الشعر حين اتسعت التراجيديا الفلسطينية، وحين خابت الآمال، وحين أخفقت الوعود، وحين تغبّشت الرؤيا، وحين أنزوى التاريخ الذي وجدناه مكتوبًا في زوايا معتمة، وذهبت إلى كتابه السرد «قصة، ورواية» وحين لاقيتُ الترحيب والتقريظ النقدي والرضا الروحي، واصلت الكتابة بهمّة من خلق لأجل كتابة السرد الأدبي، وكنت أبتسم وأنا في عزلتي ووحدتي حين أرى الشعر يطلّ برأسه من بين سطور السرد، وحين أرى المجاز يطير بالحكاية ويحلّق بها بعيدًا. أعترفُ بأن مغامرتي الشعرية كانت مفتاحي لباب السرد الثري. - كروائي أخلصت لفلسطين من خلال ما كتبته عن واقع الفلسطينيين في المخيّمات التي قلت عنها إنها تتشابه بمعاناتها داخل الوطن الفلسطيني المحتل وفي المنافي، وأنجزت روايات عدة، إلى أيّ حدّ يقلقك هذا الواقع، وماهو جدوى الكتابة ولا صدى لصوت الكاتب في غالب الأحيان..؟
- الأمر موجع وأليم أن تغادر مكانك الأصلي مطرودًا أو مهجّرًا وباكيًا لتعيش في خيمة ضيقة، في مخيم ضيق بعد أن كنت تعيش في قرى ومدن مثل حيفا ويافا والقدس وطبرية وأريحا والناصرة، والأمر أكثر وحشة من ظلمة مطبقة أو خوف داهم، بل أكثر من ظلم قاتل. عشتُ في مغارة للأحزان والحنين والبكاء والأسئلة وقلّة الحيلة، مغارة اسمها المخيّم منذ طفولتي وحتى هذه الساعة، وفي بداية وعيي كرهتُ المخيّم، كرهتُ المكان، كرهتُ الفقر، وكرهت الشكوى، وكرهت البكاء، لأن الحياة كانت موتًا لكلّ أمل، ولكلّ شوق، لكن حين كبر وعيي معي عرفت أن المخيّم مكان طارئ ليس إلا، إنه منصة للإقلاع المحتوم نحو قرانا ومدننا في بلادنا العزيزة فلسطين، وعرفتُ فضل المخيّم علينا، فقد أقترع وأشتق دروبًا رائعة للإبداع، وصنع وبنى آمالًا جميلة على الرغم من أنه مكان موحش لزمنٍ موحش.
لقد جمعنا المخيّم على الحكايات الفلسطينية كقصص وأحداث وحادثات، مثلما جمعنا الرواية الفلسطينية الواحدة، وفحواها: نحن هنا في المخيمات لأن وطننا اغتصب وسُرق واحتل بالقوة، ونحن طردنا وهجّرنا بالقوة أيضًا، المخيم جمعنا على الحنين والشوق، فليس من حديث في أمسيات المخيم سوى الحديث عن فلسطين، وعن أمكنتها وعن العيش الجميل الذي كان، وعرفت أيضًا أن المخيم هو من اشتق دروب النضال الصاعدة نحو فلسطين وهو من ربّى الفدائي والطبيب والمهندس والمعلم والقائد والشاعر والروائي والفنان والمخيم هو من بنى المدارس ودور العبادة والمشافي الصغيرة ودور تعلم اللغات الأخرى والفنون عامة، والمخيّم هو من اشتق الدروب نحو المقبرة لنلحق بتواريخ الشهداء وسيرهم وقيمهم التي نتمثلها. كلُ المخيّمات الفلسطينية داخل الوطن الفلسطيني وخارجه في المنافي متشابهة، إنها كائنات مكانية تنتظر فرح لحظة العودة. الانتظار مقلق وموحش، وكثير الأسئلة، لهذا كان لا بدّ من الكتابة عنه.
- كيف يصوغ حسن حميد المعاني وهي الخارجة من رحم الحكاية، وكيف يقولها، وما الذي نمّى الحكاية في مخيلتك لتكبر وتصبح رواية…؟
- الرواية الناجحة ليس في اختيار موضوعها فحسب، وإنما في كيفية كتابتها، فالشكل اليوم، كما كان قديمًا، هو القضية التي تخيف كلّ كاتب أيّا كانت رتبة هذا الكاتب، وخبرته، وسنوات تعامله مع النص الأدبي، لأن كلّ كتابة جديدة هي تجربه جديدة أيضًا، لها أسئلتها، وزمنها ولها تشوفاتها ورجاءاتها أن تكون معانيها جديدة، وفي طيّها أنوار إبداعية جديدة أيضًا.
الكتابة حقل للقلق والأسئلة والمخاوف ولا سيما حينما يفكر المرء بالصياغة، أيّ كيفية الكتابة، أيّ التقنية، والفرق كبير ما بين الأسلوب والتقنية، الأسلوب عطاء إلهي لأنه يعبر عن الموهبة، والتقنية تتمثل في بحث العقل عن طريق للقول، عن حيلة للخروج بالمحكي من مربعه الواقعي إلى ما ينمّي الحكاية وهو المجاز، وقلب المعادلة، والتبادلية في المكانين ما بين الواقع والمجاز هما لعبة من أجل كسر أفق التوقع. أعترفُ أنه من أصعب الأدوار التي واجهتني وأنا أهمّ بكتابة رواياتي هي الصعوبة المتمثلة في البحث عن تقنية مناسبة للقول والمعنى والمكان والزمان والشخوص التي فكرت بأدوارها. عادةً، أنتهي من التفكير بموضوع الرواية وأحدده، ولكنني أتأخر كثيرًا في الكتابة لأنني لم أعثر على التقنية المناسبة، وقد حدث هذا لي في جميع ما أنجزت كتابته من روايات وقصص. التقنية حال هندسية تشبه هندسة خلايا النحل، بل ربما تشبه ممالك الخيال التي لا يدري الكاتب متى تصير إلى جانبه أو تصير طوع حبره وتفكيره.
في رواية «جسر بنات يعقوب» التي اختيرت من بين أفضل مائة رواية عربية في القرن العشرين استعملت الرمزية في الحكايات العميقة والمتقنة بصياغة وحبكة محكمة من أجل مواربة موحية للدلالة على الرسالة التي أردت إيصالها للمتلقي، كيف استلهمت الفكرة، وهل الرمزية هروب من المباشرة وسلطة الرقيب..؟
الرواية أوجعت قلبي كثيرًا، لقد ناديتها طويلًا فلم تسمع ندائي، ورجوتها أن تصير إلى يدي، فما حفلت بندائي ولا برجائي، وساهرتها طويلًا، سنوات وأزيد، لكنها لم تحفل بي ولا بسهري، قرأتُ لها كتب التاريخ والجغرافيا والميثولوجيا، وقصص الباحثين عن الأنوار والمعاني والإجابات الشافية، ولكنها لم تسلس قيادها إليّ. - قدمت للمكتبة كتابك «الذهنية العربية الثوابت والمتغيرات» تحدث عن مرحلة مهمة في التاريخ العربي على صعيد الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما الذي أردت قوله من خلال هذا الكتاب الذي عالجت في فصوله العشرة الكثير من القضايا عبر الماضي والحاضر والفرد والمجتمع والتطور والتخلف وغيرها..؟
- هذا كتابٌ استنزف عامين من عمري، فقد قرأتُ كرمى لإنجازه ألف كتاب وأزيد، ذلك لإحساسي بأنه لا بدّ من أن ينهض أحد الغيارى على الحال العربية الراهن ليطرح الأسئلة التي هربنا من مواجهتها طوال ألف سنة وأزيد أيضًا، وهي أسئلة اجتماعية بنيتها الأساسية فكرية تقوم أولًا على تشخيص الذهنية العربية، أيّ مسارات التفكير العربي الذي سيصبح سلوكًا، أيّ أن نسأل ممَ يتكوّن التفكير العربي، وما هي ماهية هذه الذهنية العربية، ولماذا نكرر الأغلاط الكبرى، ونقترف الأخطاء المشينة، وكيف نتخلص منها..؟ في الكتاب استعراض للذهنية العربية وتوصيف لها، وتشخيص لمكوناتها، ووقوف طويل وجاد على سلوكياتها وما حفلت به، واقتراح رؤيا للخروج من الأنفاق التي برعنا في شقها وعمارتها. إنه كتاب يدور في عوالم السوسولوجيا العربية ورصد مواضع الوهن والقوة، وأسباب هذا الوهن، وتلك القوة من جهة أخرى، وما الذي نأخذ به، وما الذي نذمّه ونحيّده، وأيّ الطرق نتبع، وأيّها نحيّد، إنه الكتاب الذي يحاول رسم صورة واضحة لتفكيرنا وسلوكنا منذ ألف عام وأزيد.
- تستلهم غالبية أحداث رواياتك من المعاناة، والمعاناة الفلسطينية بالذات، ويخيّم عليها طابع الحزن والسوداوية والمعاناة، ألا من بارقة فرح في تلك الروايات يبعث للتمسك بالأمل..؟
- بلى غالبية ما تقوله، في طيّة معالم المأساة وآثارها واضحة، والحزن يعمّها لأن التراجيديا اخترقت الشخوص الروائية والأزمنة والأمكنة والمعاني أيضًا؛ العطب أصاب كلّ شيء، حتى الروح لم تنجُ، ولكن، مع ذلك، لم تعرف رواياتي السوداوية والتشاؤم إطلاقًا لأن التشاؤم يمثل حالة عجز، وهذا ما لم يعرفه أبناء فلسطين حتى حين اقتلعوا من أراضيهم في ظرف زمني بغيض له علاقة بالظلم والتوحش والدموية، أو قل إنه ظرف زمني لا علاقة له بالقيم الإنسانية.
التراجيديا بكلّ صورها موجودة في رواياتي، أما العجز والسوداية فلا آثار لها ولا ترسيمات. في روايتي «تعالي نطيّر أوراق الخريف» فصلها الأخير يتحدث عن جهجهة الفجر والندى واستقبال الصباح. وفي «جسر بنات يعقوب» أهالي قرية الشماصنة يعيدون تثبيت أركان الجسر من طرفيه الشرقي والغربي فوق نهر الأردن من أجل العبور المتواصل في الذهاب والإياب، وفي رواية «أنين القصب» تتجلى وصية الجد أن تحمل عظام قبره حين يحين موعد العودة إلى البلاد حيث هي قريته التي هُجّر منها، وهكذا هو الأمر في باقي الروايات، فلا أفق مغلق في حياة الفدائيين والثوار المناديين بتحرير بلادهم، ما دامت هذه البلاد لم تتحرر بعد، ولم يصل أهلها إلى أحلامهم بعد.
- ما بين سوريا وفلسطين، والقدس ودمشق، سلكت كثيرًا من الدروب، وتحدثت عن المكان في دلالات واضحة في رواياتك، ما الذي يعنيه المكان لكاتب ذاق طعم الغربة ومرارة الفقد عن مكان آخر يحنّ إليه، كيف تعاملت مع هذه الثيمة في الكتابة..؟
- فقدُ المكان الفلسطيني هو يتمٌ لجميع أبناء فلسطين، ذلك لأن المكان هو المعيل، وهو المرآة، وهو عنصر جليل من عناصر تكوين الشعب، مثلما هو عنصر جليل من عناصر تكامل السيادة ووحدتها. نحن في المخيّمات طوّفنا طويلًا حول المكان الفلسطيني المتشظي إلى قسمين، أحدهما يمثّل المكان الأصلي، أيّ الوطن الفلسطيني العزيز، وثانيهما يمثّل المنفى في المخيّمات الفلسطينية سواء أكانت هذه المخيّمات في المنافي أو داخل الوطن نفسه، طوّفنا حول المكان الطارئ المخيّمات نهارًا كي تصير لائقة بالعمران والمجتمع البشري وما يحتاج إليه، وما يجب توفره فيه مثلما طوّفنا حول المكان الأصلي الوطن الفلسطيني العزيز ليلًا ونحن نعيد رواية المكان وسيرته، أو حين نتحدث عن جماليات المكان وتطوره الاجتماعي والعمراني والثقافي، وقد انتابتنا لوعة البكاء وما فيه من حزن في النهار والليل معًا، ونحن ندور حيارى مثل الدراويش حول المكان، لهذا رأى قارئ رواياتي كيف نذرت شخوصُها حياتها كلّها من أجل استعادة المكان كأولوية قصوى، وعودة المكان تعني عودة الوطن والعمران والسيادة، كما تعني العودة إلى البيت.
- ككاتب فلسطيني عشت في سوريا، وشهدت ما حصل فيها من مآسٍ خلال السنوات العشر الماضية، ألم يوحي لك هذا بكتابة رواية، وما حدث يوحي بمئات الروايات…؟
- بلى، أوحت لي بالكثير، لهذا، وأنا أعدّ نفسي ابن سوريا أيضًا لأنها ربّتني على القيم الوطنية والقومية والإنسانية ودرّستني في مدارسها وبالمجان، ولولا المدرسة السورية لكنت اليوم راعيًا أو عامل باطون، أو حفار قبور، ولكن المدرسة المجانية جعلتني أنال الشهادات، فأنا أحمل أعلى شهادة تمنحها الجامعات، وعددت من أهل التأليف والكتابة الإبداعية بسبب الكتب الكثيرة التي قرأتها بالمجان أيضًا، لذلك دمّرتني عشرية الدم في سوريا منذ عام 2011 وحتى الآن. لقد عرفنا ووعينا أن سوريا تدفع ثمن مواقفها تجاه قضيتي الفلسطينية لهذا خُربت البلاد السورية، وقد فجعتُ، مثلي مثل الآخرين، لهول ما حدث، وهو دموي ووحشي، وقد طال كلّ نبيل وسامٍ ونفيس من الشجرة إلى الكتاب، ومن البيت إلى دور العبادة، ومن الطفل إلى المرأة، ومن العاجز إلى الشاب العفي، وأصابني ما أصابهم من دمار وتخريب. لكلّ هذا كتبتُ ثلاث روايات عن هذه الحرب اللعينة «لا تبك.. يا بلدي الحبيب»، و«كي لا تبقى وحيدًا»، والثالثة هي «شارع خاتون خانم»، وفيها جميعًا تتجلى همجية الحرب، وارتجافه المجتمع والقيم، وخراب المكان، وتشظيات الزمن وتعدده.
- ترجمت بعض أعمالك للغات الأجنبية، كيف كان الصدى، و«الصوت والمحتوى فلسطيني»، وهذا الموضوع الذي ما زال شائكًا في التعاطي معه في الغرب..؟
- أمرُ ترجمة الأدب الفلسطيني همٌّ وحزنٌ كبيران، لأن عدونا يخوّف كلّ مترجم، وكلّ دار نشر، وكلّ معرض للكتاب في العالم، ويحذر من التعامل مع الكتاب الذي يتحدث عن فلسطين أيّا كان هذا الحديث ومستواه، أو عن فلسطين وأهلها وجغرافيتها وتاريخها العربيين، عدونا النقيض يريد الحديث فقط عن كيان اسمه (إسرائيل) من أجل الإمعان في تغييب اسم فلسطين وأهلها، لقد فعل عدونا الأعاجيب من أجل تغيير تعريف كلمة فلسطين أو كلمة الفلسطيني في المعاجم العالمية، فاستبدل ومحا وغيّب وشطب وحوّر كلّ ما يمتّ لفلسطين وأهلها بصلة، حتى كلمة النكبة محاها وسن القوانين من أجل معاقبة كلّ من ينطق بها أو يكتب عنها، وكأن نكبة الفلسطينيين في بلادهم حدثت بيد كائنات فضائية مجهولة في حضورها وصورتها. للأسف لا أحد يجرؤ ومنذ سنوات طوال على ترجمة الأدب الفلسطيني إلى اللغات العالمية، وإن حدثت هذه الترجمة فهي تحدث في بلاد أجنبية صديقة للشعب الفلسطيني مثل روسيا والصين وإيران وكوريا.
أسماء أدبية فلسطينية كبيرة لم تعرف ترجمة لإبداعها مثل: سميرة عزام، وجبرا إبراهيم جبرا، وعبدالكريم الكرمي، وسميح القاسم، وتوفيق زيّاد، وراشد حسين، ورشاد أبو شاور، ويحيى يخلف…إلخ.
أما محمود درويش الذي ترجمت بعض قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية فقد ترجمت بمجهود الأصدقاء وبحذر شديد، وكذلك كانت الحال مع أميل حبيبي. وبسبب الخوف من تهمة العداء للسامية لم يجرؤ الغرب بجامعاته ودور نشره ومثقفيه على ترجمة إبداعات الكتّاب الفلسطينيين، ولم تجرؤ معارض الكتب الغربية على استضافة أديب أو شاعر أو مفكر فلسطيني كضيف شرف للحديث عن أدبه وإبداعه، والاستثناءات كانت قليلة ونادرة ولمن يحملون جوازات سفر غير فلسطينية. لو ترجم الأدب الفلسطيني لكانت فضيحة الكيان الإسرائيلي كبيرة ومدوية، وهزيمته الفكرية ومقولاته السياسية ودعاويه التاريخية والدينية أيضًا كانت مدوية. وخسارة العالم كبيرة لأن هذا العالم لم يعرف حقيقة إبداعات غسان كنفاني، ومحمود درويش، وجبرا إبراهيم جبرا، ورشاد أبو شاور.
- هذا السؤال يقودني لسؤال مفاده، كثيرون هم الأدباء الفلسطينيون الذين كتبوا لفلسطين وعنها، يكتبون لنا وللعرب عامة، أليس من المفترض أن يصل الصوت للخارج وهذا ما نحتاجه، لأن القضية ليست محلية، ومن المفترض أن تخاطب العالم لتصل قضيتك وصوتك، فما تُرجم لا أعتقد أنه بالكثير ويؤدي الغرض ما قولك..؟
- هذا السؤال ممزوج بالمرارة والضحك الأسود ذلك لأن الكتاب الفلسطيني لا يصل إلى بعض البلاد العربية، وهو يقف عند الحدود ذليلًا منكسرًا شأنه في ذلك شأن جواز السفر الفلسطيني. الكتاب الفلسطيني المكتوب باللغة العربية لا يصل إلى القارئ العربي، فكيف به أن يصل إلى خارج البلاد العربية والعين الإسرائيلية تراقب، واليد الإسرائيلية تذلّه وتحيّده، والحقد الإسرائيلي يواريه ويحرقه. فالنفي لم يطل الفلسطيني وحده، بل طال الإبداع الفلسطيني أيضًا. كتب وإبداعات فلسطينية كثيرة محرومة من دخول معارض الكتب العربية لأنها تتحدث عن المقاومة والدم الفلسطيني المسفوك يوميًا من جهة، وعن عنصرية العدو الإسرائيلي من جهة أخرى، مثلما هي محرومة من دخول مسابقات الجوائز الأدبية لأن الأيدي الشيطانية قادرة على تحييدها منذ لحظة وصولها وكأنها جذام.! عدم وصول الكتاب الفلسطيني إلى العالم يعني جهل عام لقضية الشعب الفلسطيني وما حدث له من اقتلاع وتشريد وتهجير وقتل وسرقة لمدنهم وقراهم وأراضيهم من قبل العدو الإسرائيلي وفي هذا الأمر شناءة عنصرية وغياب للعدالة الإنسانية ومساس بالحقوق والحريات.
- برأيك ما الذي يجذب القارئ للرواية، طريقة السرد، أم الحكاية، أم السلاسة، أم الحبكة، وهل تكتب كما تريد ذائقة القراء، أم تكتب بطريقتك وأسلوبك..؟
- كل ما ذكرته يشكل الجاذبية للذات القارئة التي ينشدها المؤلف والكاتب والمبدع وكلّ ما ذكرته يجعل الكتابة إبداعًا. أنا شخصيًا أهتم بالقارئ وأحسب له ألف حساب، ولذلك قسمت نصي إلى ثلاثة أقسام، جعلت قسمين منها للقارئ، والثالث لي، وقسما القارئ هما تقنية النص وما فيها من جاذبية ثم المتعة التي يوفرها الأسلوب والقدرة اللغوية على الاشتقاق والإثراء والتحليق، أما القسم الذي يخصّني فهو المعني بوظيفة النص وما يريد قوله، أيّ الرؤيا التي أتبناها.
أي نص أدبي لا يوفر المتعة هو نص شكاء، أي أن عيوبه التي يشتكي منها كثيرة وفي طالعها النقصان، فالنص الأدبي من دون المتعة هو نص ناقص أو قل هو فعل ناقص التتميم. - لمن قرأت من الأدب العماني، وما هو رأيك بما يقدم فيه من منجزات أدبية..؟
- عملت طوال مشواري الأدبي في الصحافة الثقافية، ولهذا أنا على معرفة جيدة بالمبدعين والنقاد والمفكرين والباحثين في البلاد العزيزة عُمان. فسلطنة عُمان اليوم جهة مهمة للثقافة والإبداع، عبر مجلاتها وصحفها وكتبها المنشورة، فهي حديقة ثقافية جميلة، وقد كان لي الحظ أن نشرت بعض ما كتبته في الصحف والمجلات العمانية، وبذلك جاور نصي نصوص المبدعين والمبدعات في عمان العزيزة. ولا أريد أن أذكر الأسماء لأن أهلها وإبداعاتهم قارة في الوجدان بكل المحبة والتقدير.
- غالبًا ما تكون العلاقة بين الكاتب والناقد متوترة، كيف تعامل النقاد مع ما كتبته، وهل يحتاج الكاتب لعلاقات وطيدة مع النقاد لكي يتصالح معهم..؟
- تتوتر العلاقة ما بين المبدع والناقد حين تترجم الكراهية إلى أقوال، وحين تترجم المزاجية إلى تهور وانحطاط، وفي هذا ظلم للنص والمبدع والناقد والذائقة النقدية.
إن دخول النقاد بمساطر نقدية إلى نص لا يعرفون عنه شيئًا، هو دخول من صمم على العراك حتى مع طيور السنونو أو مع أقراص دوار الشمس، وهذا ما يسمى بلغة أهل الفلسفة «قابلية الاستهواء» التي تسبق الفعل، أي الاستعداد للخصومة من أجل هزيمة الآخر. النقد الأدبي إبداع وثقافة وأسلوب وحضور لغوي باهر، وحاجة المبدع للناقد الرائي ملحة لا ينكرها إلا جاحد، وليس الناقد والمبدع أحدهما بتابع للثاني. - هل يسعدك لقب «أديب المخيّمات الفلسطينية»..؟
- نعم، يسعدني كثيرًا لأنه يشير إلى جذري الأصيل، أعني المكان الذي هو مرآة لقلبي وروحي وللدروب التي مشيتها من أجل الوصول إلى المدن والقرى التي بناها الأجداد والآباء، والحقول التي زرعوها، وإلى دور العبادة التي جالسوا عتباتها. الشاعر السوري شوقي بغدادي كتب عن قصصي ورواياتي مرّة فقال: حسن حميد أديب موظّف لدى المخيّم الفلسطيني. وأنا كذلك بحقّ، لقد وظّفت كلّ موهبتي وثقافتي وأحلامي من أجل أن أتحدث عن المخيّمات وفضائلها، وما أنجبته من فدائيين وعلماء وأدباء وفنانين وصابرين صاروا أمثلة للمعاني البارقة بالضياء، فالمخيّمات غدت أمكنة للنضال تزار، بعدما كانت مدونة للحزن والفقر والشكوى والأسئلة الحائرة. إن أيدي الأحفاد عمّرت المخيّمات بالمعاني والحضور، مثلما عمّرت أيدي الأجداد القدس وعكا وحيفا وأريحا وطولكرم في عام 2009.
https://www.omandaily.om/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/na/%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%86%D8%B5-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A1?fbclid=IwAR1ybwwOMB1lWkWRPdnmwdEDVB_SRT0_q410pmPXEN8hnODQmFnAeKUZoiU