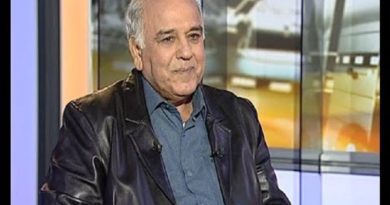المقاومة: لماذا يَجبُ أن نُديمَ الاشتباك؟ – د. وسام الفقعاوي
نشر في موقع اشتباك عربي
يتضح لنا من القراءة المتأنية لسلوك وممارسات ومنهج المشروع الصهيوني، منذ انعقاد مؤتمره الأول في بال (سويسرا) عام 1897، أن هذا المشروع انضبط لأهدافه التي تأسست على فكرة اغتصاب أرض فلسطين ونفي وجود شعبها، وكان ذلك من خلال العمل على خطين متوازيين: أولهما، بناء مؤسسات الدولة الصهيونية، قبل أن تصبح حقيقة واقعة عام 1948، من خلال الدور الطليعي للوكالة اليهودية وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لتلك المؤسسات التي رعتها دولة الاستعمار البريطاني في حينه. وثانيهما، توظيف الحد الأقصى من عمليات التخويف والإرهاب المنظم والمجازر الدموية الهادفة إلى دفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسريّة عن قراهم ومدنهم وضرب وجودهم المادي والمعنوي، وعلى الرغم مما حققه المشروع الصهيوني من انتصارات كبرى على طريق تحقيق أهدافه، والحفاظ على امتلاك كل عوامل القوة، إلا أنه مستمرٌ في إعادة صياغة وتكييف بناه وأدواته واستراتيجياته، بما يحفظ له منجزاته المحققة من جانب وَيُؤمِن شروط الاندفاع لتحقيق المزيد من أهدافه الاستعمارية العدوانية والتوسعية العنصرية، وإن بدا نظامه السياسي في السنوات الأخيرة في حالة استعصاء داخلي، لكن ذلك لم يؤثر على “تقدم” مشروعه التاريخي المعادي والنقيض لوجودنا وحقوقنا.
في مقابل واقع العدو هذا؛ يَحضُر واقعنا العربي والفلسطيني منه بالذات ليظهر مدى أزمته البنيوية التاريخيّة المركّبة التي ترافقت مع المشروع السياسي الفلسطيني منذ بدايته، حيث تضافرت معها آلياتٌ داخليّةٌ وخارجيّة، جعلت هذه الأزمة تستمرُّ وتتعمّق وتفعل فعلَها في كامل البِنية السياسيّة والمجتمعيّة الفلسطينيّة؛ إذ لم تنجح كلُّ محاولات الخروج منها، رغم الاعترافات المتواترة بوجودها، والتي كان أبرز تجلياتها المستمرة حتى اللحظة: ضرب أسس المشروع الوطني التوحيدي (مشروع التحرير والعودة)، وعدم القدرة على صياغة استراتيجية مواجهة وطنية تحشد طاقات الشعب الفلسطيني وتوظفها في إطار الصراع التاريخي مع العدو والمشروع الإمبريالي – الصهيوني، وغياب أو تغييب المؤسسة/الجبهة الوطنية الجامعة، ومن ثم الانقسام السياسي بأبعاده كافة، إلا أنه ورغم ذلك التراجع أو الانكفاء التاريخي في سياق الأزمة العامة، لم يخلو المشهد الفلسطيني بالمطلق من رد الفعل الشعبي الفردي والجماعي، على العدو الصهيوني ومشروعه من جهة، وفي رفض واقع الحال الفلسطيني القائم من جهة أخرى؛ أظهرت في مضمونها ومستوى عطائها وتضحياتها وتأثيراتها على مجرى الصراع؛ بطولة منقطعة النظير، ملأت مساحة فلسطين التاريخية، في تأكيد على أن المقاومة والكفاح الوطني واستمرار الاشتباك التاريخي هو ما يوحد الشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك؛ خزين ضميره الجمعي وامتداد تجربته الغنيّة ووعاء ذاكرته الحيّة المستمرة في حفظ أسماء وبطولات الشهداء من الزير وجموم وحجازي، مرورًا بالقسام والسعدي وأبو جلدة والحسيني وأبو دية، وصولًا إلى غسان كنفاني وأبو جهاد الوزير والياسين وأبو علي والشقاقي والقاسم… وليس انتهاءً بأبطال كتيبة جنين من جميل العموري ورعد وعبد الرحمن خازم والطبيب عبدالله أبو التين… وعرين الأسود من أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف المبسلط وتامر الكيلاني ووديع الحوح ورفاقه الشهداء.. إنه مداد الضمير اليقظ والذاكرة الحيّة والتجربة المُحمرّة بالدم.
الكتيبة والعرين تجاوز للفصائلية أم استمرار للاشتباك؟
لا يمكن لأي قارئ حصيف أو متمعن في تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله أو حتى مُطلعٍ عليه، إلا ويدرك أن هذا النضال لم ينقطع لحظة واحدة بكل ما تعنيه الكلمة عن مواجهة الغزوة الصهيونية، منذ أن وُضِعَت مداميك أول مستوطنة زراعية صهيونية (بتاح تكفا) على أرض قرية ملبس، وقاومها الفلاحون الفلسطينيون، دون انتظار أن يكتمل شكلًا تنظيميًا ما، ينضموا في إطاره كي يقاوموا الغزوة، وهذا هو الحال عندما قامت الانتفاضات والهبات والثورات في أعوام 1919 و 1920 و 1929 و 1935 و 1936 – 1939 وما قبلها وما بينها، حتى بالتشكيلات العصابية “الثورية” التي برزت مع ظاهرة الشيخ المجاهد عز الدين القسام، الذي لم يكن ملتحقًا بأي تنظيم فلسطيني في حينه (بل هذه في معظمها لم تشارك في جنازته شهيدًا)، مرورًا بالثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت لثلاث سنوات، وإن كان هناك ما سميَّ بحالة جامعة (الهيئة العربية العليا) التي ضمت في رأس قيادتها أبناء كبار العائلات والمُلاك، وناظرها تشكيلات ثورية جماعية، على نطاق كل مدينة وقرية، كانت تحت أمرة الثوار الفعليين الذين امتشقوا السلاح في مواجهة قوات الاستعمار البريطاني وطلائع الهجرات الصهيونية، إلا أنها كانت جميعها تفتقد إلى مفهوم التنظيم بالشكل الحديث الذي امتلكته الحركة الصهيونية، والذي بدوره أفقد تلك التجربة أن تكون لها بناها التنظيمية الثورية الموحدة واستراتيجيتها الواضحة وقيادتها المتماسكة والواثقة، لذلك وجدنا من الفلسطينيين من تطوع مع البريطانيين في القتال ضد الثوار (حزب الدفاع وغيره)، ولعل كتاب غسان كنفاني (ثورة 36 -39 في فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل)؛ مفيد للوقوف على تجربتها. ورغم الهزيمة التي لحقت بالثورة والثوار والشعب الفلسطيني إجمالًا وما ترتب على ذلك وصولًا إلى الهزيمة/النكبة عام 1948، إلا أن كل السياق الثوري الذي سبقها، على ضعف بناه واستراتيجياته ووضوح أهدافه وتماسك وثقة قياداته؛ عبر بكل ما تعنيه الكلمة أيضًا، عن الروح الكفاحية التي تختزن داخل عقل ووجدان وأحشاء الشعب الفلسطيني الذي ليس استثناءً عن أي شعب يواجه غزوًا استعماريًا، لكنه كان من أكثرها تعرضًا للاقتلاع وضرب وجوده المادي الطبيعي على أرض وطنه، ولعمليات تطهير عرقي متلاحقة، وتشتيته في أصقاع الأرض؛ ارتباطًا بطبيعة وجوهر المشروع الصهيوني الاستعماري الإجلائي والعنصري التوسعي.
وعليه، لم يكن أمام هذه النفسية الجريحة بسرقة أرضها، والمهانة كرامتها باللجوء، والذبيحة بالخذلان والخديعة والخيانة، إلا أن تستمر في اجتراح وسائل مقاومتها وإدامة ثورتها التي وجدت ملاذًا لها في صعود المد القومي وتشكيلاته من حزب البعث مرورًا بحركة القوميين العرب والناصرية التي مثلت أقصى صعود للحالة القومية الشعبية، وكذلك أقسى هبوط لها بعد الهزيمة/النكسة عام 1967 – مترافقة فترة ما قبل الهزيمة مع العديد من التنظيمات والتشكيلات السياسية والعسكرية في معظمها من جبهة تحرير فلسطين وجيش التحرير الفلسطيني إلى أبطال العودة وشباب الثأر وحركة فتح… والعديد غيرها – ومن ثم صعود الحركة الوطنية الفلسطينية بتنظيماتها التي تمثلت تجربتها في منظمة التحرير الفلسطينية وشكلت مظلةً وكيانًا معنويًا وقانونيًا للشعب الفلسطيني، وعبرَّ من خلالها عن أهدافه وتطلعاته وحقه في التحرير والعودة وتقرير المصير، وانضوى معظم أبناء الشعب الفلسطيني تحت رايتها قتالًا، واستبسالًا، واستشهادًا، واعتقالًا، وتضحيةً.. وهنا لم ينقطع الحبل السري الثوري بين مواقع شتات نشأة وانطلاق هذه التنظيمات (في حين أن المنظمة أُعلن عن تأسيسها من القدس )، وبين الداخل الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال المباشر. وعليه؛ تواصل هذا الحبل في إنتاج الحالة الثورية والكفاحية في الداخل ببناها التنظيمية وتشكيلاتها العسكرية وانتفاضاتها الشعبية من الأرض عام 1976 إلى الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987 وما بينها، التي طُلبت رأسها على طريق إجهاضها وقطع تطور مسار نضال الشعب الفلسطيني، من بوابة النيل من رأس قيادتها/تنظيماتها/منظمتها، وهذا ما حصل من خلال مدريد – أوسلو، بما مثله الأخير من اتفاق تاريخي صب في مصلحة المشروع والوجود الإمبريالي الصهيوني في بلادنا، بالمعنى السياسي والقانوني والأمني. لكن السؤال الموضوعي: هل انقطع حبل النضال، رغم أن حلقة الوصل (المنظمة) تحولت من مشروع التحرير إلى مشروع التمرير للتسوية والاعتراف بوجود العدو الصهيوني وتطبيعه على أرض وطننا العربي الفلسطيني؟!
هنا من يجيب هو الضمير الجمعي الفلسطيني وذاكرته الحيّة التي تحتفظ وتختزن في داخلها بتجربة ممتدة لما يزيد عن قرن من الزمان في المواجهة والاشتباك، بكل ما في هذا التاريخ الكفاحي الثوري؛ من صعود وانكسار ووصل وانقطاع، ويعطي في كل مرة ما هو أنصع وأكثر وضوحًا ثوريًا من كل التجارب المريرة والهزائم العسكرية والسياسية المتكررة، ولم يكن ينتظر إشارة بدءٍ من أحد، وهنا تتجلى الشرعية الكفاحية، التي تشكل ناظمًا لوعي الشعب الفلسطيني، الذي يتقدم الصفوف عندما تتأخر “مؤسساته وتنظيماته”، وبكلمة أدق هو تعبير عن النفسية الكفاحية المتأصلة في الذهنية الشعبية عمومًا، رغم كل محاولات التجويف، والتجريف، والإنهاك، والإفساد، والإفقار، والتزييف، والتزوير الممنهج، الذي يُمارس منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة. ففي ميدان الكفاح والمقاومة والاشتباك؛ ـتتأسس الشرعيات التي لم يبحث عنها أصحابها؛ شرعية الذين يقفون على الأرض؛ يصنعون فعلًا لا قولًا ردًا على الهزائم العسكرية والسياسية، بدماء لم تستكن لعواء من ساوم على القضية في صحراء أنظمة الذل والخيانة… متوحدين في الروح التي أعادت صقلها مهانة الهزيمة والانقسام ومرارتيهما المستمرة.. تجربة متدفقة لها روحها ورجالها ونسائها وشرعيتها، حيث أبدعت روحهم فكرة: أن تبيع المرأة حُلِيّها كي تشتري لزوجها أو ابنها بارودة أو التبرع بنصف كيلو دم طازج؛ يُباع ليصبح ثمنه رصاصة أو رغيف خبز أو أن تزغرد أجمل الأمهات ولا تنزوي في ثياب الحداد أو تُلقي التحية العسكرية لابنها وتحمله على كتفها بانتظار شهيد آخر يعطي لنهر التجربة رافدًا جديدًا… أي “جنون” ثوري جميل هذا؟! وأي شعب ذاك القادر أن يُبقى جداول النهر مُحمَرَةً باستمرار؟!
الجواب هو وباختصار؛ من قوات المقاومة الشعبية (كتائب أبو علي) إلى كتائب شهداء الأقصى والقسام وسرايا القدس والمقاومة الوطنية، إلى كتيبة جنين وعرين الأسود وكتيبة بلاطة وما سيظهر من تشكيلات ممتدة أو مشابهة، هي حلقة الوصل المستمرة في تجربة الشعب الفلسطيني الكفاحية التي لم تنقطع عن جذورها التاريخية من هبة فلاحي قرية ملبس ضد أول مستوطنة إلى بطولة عدي التميمي منقطعة النظير على حاجز شعفاط وفي قلب مستوطنة “معاليه أدوميم”؛ إنها استمرار لتلك الشرعيات التي تأسست في ميدان الفعل التاريخي في اللحظة التاريخية من الصراع التاريخي بمرجعياته ومساره ومحدداته. وكذلك بالمقابل، هي تعبير عن أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية التي لم تعد بالإمكان إخفائها أو تمويهها أو تجاوزها، بل يجب الاعتراف أن الأزمة الوطنية العامة، التي وصلتها القضية ومشروعها الوطني لا يمكن أن تحال بالكامل إلى عجز “القيادة التاريخية” عن الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الأهداف المعلنة بـ “التحرير” في مرحلة أولى و “المرحلية – الدولة المستقلة” في مرحلة تالية، بل أيضًا إلى عجز “المعارضة التاريخية” في أن تصبح البديل الذي طالما قال أن في برنامجه الدواء الشافي، وأنه نقيض برنامج السلطة المأزوم. وعليه؛ فإنه في سياق هذه الأزمة، يجب أن تُقرأ أيضًا تشكيلات المقاومة التي ملأت المشهد الشعبي؛ فخرًا واعتزازًا وكبرياءً ببطولاتها الفردية والجماعية؛ دون أن يخرج أحد منها ليقول بأنه عابرٌ للفصائل أو متجاوزٌ لها، بل لم يتوانوا عن التأكيد أنهم امتداد لها ورافد من روافدها – ولم يعد خافيًا من يقف خلفها؛ دعمًا واسنادًا وتجهيزًا – في وقت انبرى فيه بعض الكّتبة ومرتزقي مؤسسات الأنجوز، وكذلك من الكتَّاب والمثقفين الوطنيين الأخذ بهذا القول، ووصل أحدهم للقول بأننا نشهد مرحلة انطلاق الفصائلية الفلسطينية الثالثة.. فكما الحياة متجددة، فإن المجتمعات ومؤسساتها الوطنية والمجتمعية متجددة أيضًا، لكن هل اُستنفذ الدور التاريخي للفصائل، كي نصل للقول؛ بعبور وتجاوز الأيديولوجيا والأهداف الاستراتيجية والفصائل والأدوات الكفاحية..؟ وهل هي دعوة إلى مشروع كفاحي جديد كبديل تاريخي في الرد على الهزيمة والمشروع المعادي وأهدافه التصفوية؟ أم هي أقوال ودعوات لتعميم المزيد من الفوضى والتعميَّة على أهداف العدو الرئيسية، خاصة وأن عمليات استهداف التنظيمات (جز العشب)، والتشكيلات العسكرية من كتيبتي جنين وبلاطة وعرين الأسود في الضفة إلى استهداف تشكيلات المقاومة وحاضنتها في قطاع غزة، بالقتل، والاغتيال، والاعتقال، والتحييد، والاحتواء، ووضع الجميع تحت سقف المساومة التاريخية على كامل الحقوق الفلسطينية تجري على قدمٍ وساق؟ ألا يمكن أن يُفهم من أقوال العبور والتجاوز بأنها محاولة للقطع المَرَضي أو المقصود للاستمرارية التاريخية لكفاحية الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني التحرري؟!
فنحن “أمام مفارقات هذه اللحظة أنها لحظة يريدها الجميع، ولا يريدونها في ذاتِ الوقتِ، يشجعونها ويخافون من تناميها، ويحجمون عن دفع أثمانها في ذاتِ الوقتِ؛ لحظة حيّة في ظل واقع مميت، قوتها في ضعفها، وثراءها في فقرها، وعمق تأثيرها يكمن في بساطة أفعالها؛ لحظة قليلة الخطابات والكلمات، مع أنها تملك بلاغة التأثير والحضور؛ وكأن قدر الكفاح الفلسطيني، أن يخوض اشتباكه المفتوح مع كلِ شيء؛ مع نفسه ومع أعدائه، قدره أن ينبعث من تحت الركام، وأن يقف إذا خارت قواه، ويصنع مفخرة التحدي والبقاء مهما بلغت التضحيات”[1].
باختصار وتكثيف وفي محاولة تأمين بعضٍ من الجواب الذي بحاجة لنقاش أوسع وأشمل، يمكن القول بأن معرفة الواقع والانطلاق منه؛ تشكل نصف المسافة للوصول للهدف/الحقيقة، وأن الوطنيين الثوريين لا يتهيبون الحقيقة والاعتراف بواقعهم وأخطائهم، ولكن الحقيقة أيضًا هي أن من كانت حقيقته كلها خطأ بخطأ، ولم يكن يومًا ما، بأي نسبة ما ثوري، وأن من لا يعرف كيف يُنصف نفسه ويَعدِلُ معها لن يكون منصفًا مع الحقيقة، وما يمارسه هو شيء ما، لكنه ليس نقدًا أو اعترافًا بالأخطاء. هنا تتبدى بوضوح المسافة بين الثورية وحقيقتها وواقعها ونقدها العلمي القائم على التواصل وعدم القطع وحفظ الإيجابيات والتركيم عليها وبين جلد الذات والقطع المرضي المتشنج معها، بدافع التوهم بنقد واقع الحال أو بدعم مُسبق الدفع، وليس بعيدًا عن أجندة الاحتلال!
عن المشروع المعادي: قراءة ليست جديدة
نشأت الفكرة الصهيونية ومن ثم المشروع الصهيوني في أحشاء الفكرة الاستعمارية الأوربية التي منحت الحق “للرجل الأبيض”؛ استعمار وقهر الشعوب الأخرى؛ الأدنى منها تطورًا ورقيًا وحضارةً، لكنها زاخرة بالموارد الطبيعية الغنيّة، بدءًا من الذهب الأصفر وليس انتهاءً بالذهب الأسود “النفط”، وعلى ذلك؛ فإن فهم جذور المشروع السياسي الصهيوني، لا ينفصل عن كونه تجسيدًا لأيديولوجيا بعث الشعب اليهودي إلى الأرض التي “اختارها له الرب يهوه”، بحسب الرواية التوراتية المُختلقة، مما وضعنا أمام حركة أيديولوجية، عملت على الربط التاريخي والمضموني بين الرؤية الصهيونية الاستراتيجية، والروايةِ الدينية التوراتية، والمشروع السياسي المباشر لـ”إسرائيل” العنصرية. وعليه؛ فإن الأيديولوجية الدينية والسياسية الصهيونية ركيزتها إنشاء الدولة اليهودية التي ينتمي إليها كل اليهود، سواء من يقيم منهم على أرض فلسطين التاريخية أو اليهود في دول العالم كافة، وهي كذلك القوة الفكرية المحركة والدافعة لمسلكيات دولة العدو في المناحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وكذلك في علاقتها من الأغيار أو “الغوييم”، وهذه الأيديولوجيا هي ذاتها التي قدمت التبرير -القومي- لهجرة اليهود إلى فلسطين مطلع القرن العشرين، وحصلت بموجب ذلك على حماية وحضانة ودعم الدول الاستعمارية الغربية التي يسرّت لها الهجرة والاستيطان، مما كرّس الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية في أهدافها التاريخية من جهة، ومن جهة أخرى العنصرية الإرهابية في سلوكها التنظيمي والسياسي والاجتماعي.
بناء على ذلك؛ عدَّ القادة الصهاينة بأن القوة هي الوسيلة الرئيسية لإحداث المتغيرات والتحولات التي تدفع مشروعهم، وكذلك هي الضمانة لتحقيقه على الأرض، لهذا اعتنق أغلب القادة الصهاينة من ديفيد بن غوريون “أول رئيس وزراء إسرائيلي”، إلى يائير لابيد “رئيس الوزراء الحالي”؛ أفكار الكاتب الصهيوني زئيف جابوتنسكي (الجدار الحديدي – نحن والعرب)، والذي أكد فيه أن العرب لا يمكن أن يقتنعوا ويسلّمُوا بوجود الدولة اليهودية، إلا باستخدام القوة، وإذا لم تصلح القوة؛ فيكون بمزيدٍ من القوة، وهذا يجعلنا نفهم أساس الاقتلاع وضرب الوجود المادي والمعنوي والتطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني قبل إنشاء دولتها، وكذلك استمرار هذا الاقتلاع والتطهير من خلال الاستيطان والقتل اليومي وعشرات القوانين العنصرية وإنكار الحقوق السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. وهنا “لا غرابة في أن نجد العديد من المشتركات الفكرية بين النازية والصهيونية، والتي تشكل الإطار الناظم لكل منهما: القومية العضوية المرتبطة بالدم والأرض، والتي بدورها تستبعد الشعب العضوي الآخر، والنظريات العرقية، وتقديس الدولة، وكذلك في التماثل البنيوي في الربط بين القومية (الشعب المختار) والأرض”[2]. إن الفلسفة والممارسة الإسرائيلية هما ميراث ممتد لما قبل نشأة دولتها المعادية؛ يعود إلى توجيه قادة الحركة الصهيونية بضرورة بعث مشروع وبناء الأمة على أرضها التاريخية، حيث كانت فكرة بعثهم من جديد على حساب إنكار شرعية الحركة القومية العربية الفلسطينية، ومن على قاعدة تأكيد شرعية وأخلاقية وحصرية الشعب اليهودي في كل فلسطين. وانطلاقًا من هذه المحددات التي تقوم على نفي الآخر وادعاء الملكيّة الكاملة والحصرية لأرض فلسطين للشعب اليهودي لا غير؛ جاءت الممارسة السياسية الصهيونية منسجمة مع الفكر السياسي الذي اِنبنت عليه تلك الممارسة التي تهدف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي، بحيث تم التعامل مع الفلسطينيين سواء داخل أراضي عام 1948، أو غيرها كجماعات ليس لها هوية سياسية قومية واحدة، وقسمت هذه الجماعات إلى طوائف دينية: مسيحيين ومسلمين ودروز[3]. لذلك؛ لم يسبق لمسؤول إسرائيلي أن تحدث عن حقوق للشعب الفلسطيني، بل هذه الكلمة تغيب من القاموس السياسي الإسرائيلي لحساب كلمة الأقلية العربية أو السكان العرب أو الفلسطينيين بالعموم؛ لأن ورود كلمة شعب، تعني الاعتراف بوجود قومي لشعب آخر؛ يشارك الإسرائيليين وينازعهم في ملكية الأرض، في حين أن كلمة أقلية أو سكان، تحيل لحقوق اجتماعية وثقافية لا حقوق سياسية.
وعلى الرغم من أن هناك العديد من المؤرخين الإسرائيليين وغيرهم ينفون الفكرة الصهيونية، بما في ذلك وجود قومية واحدة تجمع اليهود في العالم، من خلال تأكيدهم أن الحركة الصهيونية استفادت من رُكام أبحاث مفبركة، لبعث فكرة “الشعب اليهودي الواحد”، بهدف اختلاق قومية جديدة، وبهدف شحنها بغايات استعمار فلسطين، وما ترتب على هذا من أن الوطن -فلسطين- عائد إلى الشعب اليهودي وإليه فقط، لا إلى أولئك “القلائل” – الفلسطينيون- الذين أتوا بطريق الصدفة ولا تاريخٌ قوميٌ لهم، وفقًا لمزاعم تلك الحركة. لذلك؛ فإن حروب إسرائيل المستمرة هي لحماية الوطن؛ فهي حروب عادلة بالمطلق، أما مقاومة السكان المحليين الأصلانيين فإنها إجرامية، وتبرر ما اُرتكب ويُرتكب بحقهم من آثام وشرور، مهما تبلغ فظاعتها[4]، إلا أن إسرائيل لم تكف عن اختلاق تاريخ خاص بها، مبني على الرواية التوراتية، التي لم يثبت أن لها أي وجود أركيولوجي في أرض فلسطين، رغم كل التنقيبات والحفريات التي جرت وتجري منذ بداية القرن التاسع عشر في مختلف المناطق الفلسطينية، وخاصة ادعاء وجود مملكتي إسرائيل القديمتين على أرضها “يهودا والسامرة”، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ما تزال مراكز الأبحاث والدراسات الإسرائيلية تساهم في ضرب الرواية التاريخية العربية الفلسطينية، من خلال ربطها للقومية الإسرائيلية بالدين اليهودي، وهذا يعد خارج السياق العلمي والاصطلاحي لتعريف القومية التي لا ترتبط بالدين، بل بمقومات تاريخية واجتماعية وسياسية وثقافية، إضافة إلى عملية التهويد المتدرجة للأماكن والبلدات والأحياء والشوارع العربية، من خلال استدعاء أسماء يهودية توراتية في الأغلب؛ مدّعمة ذلك بإجراءات قانونية وسياسية؛ “لأن إسرائيل تريد أن تُرسي وجودها على حساب الوجود الوطني الفلسطيني متوسلة – في ذلك بالإضافة إلى العنف والإرهاب والاستيطان – منطلقات تاريخية مشوهة ومقولات كاذبة كالقول: شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، ونفي وجود الشعب الفلسطيني، وما صاحب ذلك من معالم الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية”[5].
لقد اتسمت الاستراتيجية الصهيونية بطول النفس والثبات والتماسك واستمرار التقدم من موقع إلى موقع آخر متقدم أكثر، ولعلَّ الجوابَ المعزّزَ والمستندَ إلى وقائعَ كافية؛ هو امتلاكُ المشروعِ الصهيونيّ لديناميكيّةٍ عاليةِ الفعاليّة؛ تعودُ أساسًا إلى ارتفاعِ مستوى المؤسّسةِ التي رعت وأدارت المشروع، سواءً أكانت نخبةً قياديّةً، أو نظامَ عملٍ وآليّاتٍ، أو رؤيةً، وقوّةَ دفعٍ أيديولوجيّ (دينيًا وفكريًا وعلميًا) – مع الأخذ بعين الاعتبار أن النواة المؤسسة في أغلبها كانت ملحدة وعلمانية، وفي مقدمتها مؤسس الصهيونية السياسية ثيودور هرتزل – وإلى خبرةٍ تاريخيّةٍ تأسَّسَ لها مع انعقادِ المؤتمرِ الصهيونيّ الأوّل قبل خمسينَ عامًا من إقامةِ الدولة التي تقرّرت فيه. فإذا كانت هذهِ هي الصورةُ للمشروع المعادي، حيث جمع بين ميزانِ قوًى مختلٍّ لصالحِهِ، وبين الخبرةِ التاريخيّة التي وضعته في مكانٍ متقدّمٍ في إدارة الصراع، ومؤسّسةٍ عاليةِ المستوى؛ ماذا كانت الصورة على المقلب الآخر، أي العربي والفلسطيني، فهي وبدون أدنى حذر افتقدت لكل ما سبق؛ عدا الحق التاريخي، فكما هو معروف ففي الصراع التاريخيّ – كما كلّ صراعٍ – ثمّةَ محدّداتٌ قسريّةٌ، وقواعدُ يصنعُها الطرفان، وحين لا تُحترَمُ هذهِ القواعدُ عند القراءةِ التاريخيّة، وسيرورتِها العمليّةِ التي يقومُ بها كلُّ فريقٍ من فرقاء الصّراع، فإنّ النتيجةَ تكون وبالًا؛ لأنّ من لا يحترمْ قواعدَ الصراع، لا يأخذْ بعينِ الاعتبارِ الطرفَ الثاني الذي يصارعُه، في حين أنّ الاختبارَ الحقيقيَّ لما يملكُ أيُّ طرفٍ من إمكاناتٍ ماديّةٍ ومعنويّةٍ وكفاءةٍ في إدارة الصراع؛ تُختَبَرُ في ميدانِ المقابلةِ بينهما، وليس للرغباتِ والنوايا والحق ِّأيُّ فعلٍ مقرّرٍ في تعديلِ ميزانِ القوى القائم[6]. وهنا يجب أن نضع نصب أعيننا قراءة العدو الصهيوني من بوابة قراءة علاقته العضوية مع البنى الاستعمارية والإمبريالية التي مثلت حاضنًا وداعمًا وحاميًا له؛ فهو خرج من صلب “رجلها الأبيض”، أي بنيتها الاستعمارية التي جعلت من اليهودية الصهيونية عرقًا ودينًا، وساميتها بقرة مقدسة، وتوراتها مرجعًا لشعبها المختار، واختلقت تاريخها الضارب في “جذروه” ليصل إلى الرب يهوه، وهذا بدوره ما يجب أن يتأسس بشرعية قبوله من أصحاب الأرض/الحق. وهنا يجب أن نقرأ أيضًا ذاك التحالف القديم – الجديد بين أنظمة سايكس بيكو وامتداده أنظمة اتفاقات إبراهام. وعليه؛ فإن البنى الاستعمارية (معسكر الأعداء): الاستعمار والإمبريالية والصهيونية وأنظمة الرجعية والخيانة العربية التي ليست أكثر من تابع ذليل للأولى؛ ستبقى متحفزة دائمًا لمشروعها، ولإعادة دورة إنتاجه باستمرار، بما يجعله يتقدم بخطى “واثقة” في إطار تقييمه ومراجعته الدائمة، في مراكز ومعامل بحثها التي لا تكف عن مراجعة الذات، ولكن ليس من على قاعدة محاسبتها على أخطائها بحقنا، بل من على قاعدة مراكمة إنجازاتها والقفز لتحقيق ومراكمة المزيد منها، وهذا ما يحصل بالضبط.
ومن نافل القول هنا، أن البنى الاستعمارية لا تكتفي بحرب الإبادة والتطهير وضرب الوجود المادي للشعوب/المجتمعات التي تحتلها، أو الخاضعة لهيمنتها، ونهب خيراتها، ومقدراتها وثرواتها، بل تعمل على هندستها، من خلال أنظمتها السياسية وبناها القيادية بما يجعلها تستجيب لمقتضيات مشروعها الاستعماري، من حيث تدري أو لا تدري، وهذه الهندسة، لا يمكن أن تنجح بالتدخل الاستعماري المباشر لوحده، لأنها تجعل المُستعّمَر، في حالة دائمة من الاستنفار والممانعة والمقاومة للمُستعّمِر، لذلك فالأخير بحاجة لأدوات داخلية، تعينه وتساعده في تحقيق مشروعه، هنا يحضر دور الوكلاء الذين يصبحون خبراء، والمقاولون الذين يتحولون من حركات سياسية إلى شركات أمنية، والعملاء الذين يبررون لأنفسهم ويبرؤونها بإدانتهم لواقع الحال المُزري، والتجار الطبقيون الذين عندهم الربح وتراكم رأس المال، أقدس وأعظم من الأوطان، والكثير من ما يسمى بالمؤسسات غير الحكومية التي مطلوبٌ منها أن تُنجز بقدر ما تتموّل، والملوك والرؤساء الذين لم يعد يهمهم حفظ البلاد، بقدر ما يهمهم حفظ رؤوسهم وليس عروشهم فقط. وعليه؛ لا غرابة أن يتصدر جزءًا من هؤلاء المُهَنّدَسين المشهد، كما المستويات المتقدمة في صناعة القرار وتزييف وتشويه الواقع وتمويه العدو ودوره وأهدافه، والخلط بين الوطني وغير الوطني، النقي وغير النقي، الشريف وغير الشريف، الصحيح وغير الصحيح، الصادق وغير الصادق، وصعوبة التفريق بينهما.. بحيث تستمر دائرة التشويش والفوضى وفقدان المعايير واختلال التوازن، على طريق التآكل الذاتي المستمر للبديهيات والمسلّمات والحقائق والثوابت، مترافقة مع سلب وتآكل الإنسان حقوقًا، وحضورًا، ووعيًا، ودورًا، وتبديدًا لأوصال وطنه، وصولًا لفقدان الأمل بالقدرة على المواجهة وتحقيق الأهداف الوطنية، وهنا يجب أن نستلُ بكل جرأة وشجاعة ووضوح؛ سلاح الفعل المقاوم أكثر من أية مرحلة أخرى.
أدوات وأشكال النضال: استمرارية الفعل المقاوم
إن تحديد الهدف يساهم في تحديد الأساليب النضالية التي تمكّن من تحقيقه وبلوغه؛ لذا فإن الفكر الثوري بنظرياته المتعددة وبالأخص منها النظرية الماركسية؛ أعطى الاهتمام الشديد لأشكال النضال المختلفة، التي تتناسب وتطور حركة الجماهير والتحولات والتغيرات التي تطرأ في مجرى الواقع، دون إهمال هذا الشكل أو ذاك من أشكال النضال، فهذه المسألة لها أهميتها المتميزة لكافة القوى الثورية الطامحة للاستقلال الوطني والتغيير الاجتماعي؛ فالتحديد السليم لترابط أشكال النضال، يمثل مكانة خاصة زمن احتدام الصراع والاشتباك سواء مع العدو الوطني أو الطبقي؛ انطلاقًا من تحديد سليم لمبادئ وأساليب العمل التي تتناسب وتتلاءم وتطور الأحداث وطبيعة كل مرحلة، خاصة وأن هذه المسألة من أكثر المسائل التي تحتاج إلى روح مبدعة وخلاقة، وتتطلب استيعابًا متميزًا للنظرية الثورية في ظروف وتطور الصراع، وذلك بتحديد الشكل النضالي الملائم لهذه الفترة/المرحلة أو تلك من فترات/مراحل الكفاح الوطني.
وكان قد أشار فلاديمير لينين “قائد الثورة البلشفية” إلى أن أشكال النضال تحتاج إلى فحصٍ تاريخيٍ بحتٍ وعدم معالجتها بمعزل عن الموقف التاريخي المحدد؛ كون ذلك ينم عن الفشل، في فهم أولويات المادية الديالكتيكية… وعليه؛ فإن محاولة الإجابة بنعم أو لا عن السؤال حول ما إذا كان يجب استخدام أسلوب معين من أساليب النضال دون دراسة تفصيلية للموقف المحدد للحركة المعنيّة في المرحلة المعنيّة من تطورها، يعني التخلي تمامًا عن الموقف الثوري[7]. وقول “لينين” هذا؛ يدعونا ليس إلى فهم قوانين التغيير الصحيحة بشكل عام، بل أيضًا أن نرى ما هو جديد ومختلف وأن يكون بمقدورنا وسط كل التعقيدات أن نجد ما هو جديد وأساسي لاكتساب أقسام مهمة من الجماهير لدفعها إلى العمل، وأن نختار في كل مرحلة أشكال الصراع التي تكون الجماهير على استعداد لخوضها، وهذه بدورها تفرض إبداعًا مستمرًا، بل وتتطلب عدم الركون للصيغ الجامدة والثابتة، وذلك انطلاقًا من أن النظريات الثورية وفي صلبها الماركسية كما يذهب “لينين”، ليست صيغًا جامدة، بل هي مرشدة عمل.
إن السير بالثورة والعملية النضالية إجمالًا إلى الأمام؛ يتطلب حكمة ودراسة عالية ومتأنية لفنون النضال، من حيث المستويات والأشكال والأدوات؛ ارتباطًا بمحدد أول هو طبيعة العدو ومشروعه وأهدافه (وهذا شخصنا طبيعته أعلاه)، ومدى استعدادية الشعب لمواجهته وإدامة الاشتباك معه (وهذا يختزنه الضمير الجمعي وذاكرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الحيّة)، وانطلاقًا من ذلك، فلا مجال أمامنا سوى أن نُبدع باستمرار وسائل كفاحنا ومقاومتنا الوطنية الشاملة ولا نتوقف عند شكل منها بحد ذاته، فالثقافي كما العسكري والتنموي كما السياسي، والإعلامي كما الدبلوماسي، والجماهيري كما النقابي… ويبقى الهدف من كل ذلك هو تحصين وبناء الذات والدفاع عنها ومواجهة عدوها وتركيم خسائره على طريق هزيمته التاريخية الساحقة، خاصة وأن كل محاولات المساومة التاريخية معه؛ ثبت أنها كانت تصب في مصلحته، واستمرارية اندفاع مشروعه وتوسعه، على حساب شعوبنا العربية وحقوقها وثرواتها وهويتها ووحدتها.
صحيح أن اتفاق أوسلو فرض واقعًا وتعقيدًا جديدًا في سياق الصراع، وأضاف تكاليفًا وأعباءً أكبر، لكنه لم ينفِ جوهره وطابعه التاريخي – الموضوعي، بما يعني أن المهمة الأساسية أمام الشعب الفلسطيني، كانت وما تزال مهمة النضال الوطني وهي إنجاز التحرر السياسي والعودة وبناء الدولة الوطنية المستقلة على كامل التراب الوطني، بما يعني تفكيك وإنهاء المشروع والوجود الصهيوني لا التصالح معه. وإلى جانب ذلك، بل على طريق تحقيقه؛ مهمات النضال على الجبهة الاجتماعية، ضد القوى الرجعية الداخلية والدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية، والعمل على تكريس الديمقراطية كنظام حياة لشعب يناضل من أجل التحرر، والذي يبدأ من امتلاك حريته وضمان صون كرامته وحقوقه الاجتماعية كافة.
إن ما سبق ذكره، يحدد أشكال ومستويات النضال ما بين أيديولوجية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية وإعلامية…، والتحديد لأوجه الصراع/النضال هذه يُشكل المحتوى العام لكل حركة ثورية، حيث يصبح من الضروري لكل حركة ثورية طليعية وحزب ثوري طليعي؛ إجادة استخدام هذه الأساليب الرئيسية واتقانها وتعلم تكتيكها العام، فلا يكفي معرفة أهمية هذا الشكل فحسب، بل من الهام والإلزامي في آن؛ اتقان كيفية استخدامها أيضًا وفي توقيتها المناسب أو الصحيح، باعتبار أن النضال الذي تخوضه القوى الاجتماعية الحيّة التي تواجه ظروفًا موضوعية معيّنة من النضال الثوري؛ تكون في أمس الحاجة لذلك الاتقان.
وبهذا المعنى “فإن عملية تحديد أشكال النضال بتنوعها، وبما يناسب شروط كل مرحلة ومقتضياتها هي عملية قسرية، وهو الأمر الذي يُخرجها من دوائر العفوية والارتجال إلى دائرة الضرورة الموضوعية والوعي والرؤية الفكرية والسياسية للصراع، وبحيث يمكن صوغ سياسات عمل تحتل مكانها وتؤدي وظيفتها بصورة طبيعية، وبأعلى حد من الانسجام والتناغم فيما بينها من ناحية، ومع الواقع وشروطه وديناميات الصراع الموضوعية من ناحية أخرى[8]، وهذه الحقيقة تعني أن الصراع والاشتباك يأخذان مختلف أشكال المواجهة على نحو موضوعي لأبعد مدى ولهذا السبب، فإن أشكال النضال الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية…، في ظل معطيات الحالة الفلسطينية مفتوحة على كل الأساليب بدون استثناء، التي تكفل الدفاع عن الحقوق العربية الفلسطينية واستعادتها، وهذه الحقيقة لا يمكن أن تعمل بشكل فعَّال دون توفر شرطها التاريخي.
الشرط التاريخي راهنًا وليس آجلًا
يشكل النضال السياسي والجماهيري والكفاحي على تنوعه أحد أساليب النضال الرئيسية، التي يستخدمها الحزب الثوري في صراعه ضد عدوه الوطني والطبقي وهو تعبير عن نشاط الحزب الثوري المتنوع؛ فهو دعاية وتحريض وتعبئة بالكلمة والفعل الميداني، وهنا لا بد من توضيح أن العنف الثوري والكفاح المسلح، ليس إلا تعبيرًا عن النضال السياسي، الذي تستخدمه الجماهير بكل تنوعه ووحدته؛ فهو يمتد من الكلمة السياسية والمظاهرة الاجتماعية أو المطلبية أو الاعتصام والإضراب والوقفة التضامنية كأشكال مهمة لتحشيد أكبر الطاقات الشعبية وجماهيره إلى الكفاح المسلح كشكل ثوري خاص. ولذا؛ فإن الحديث عن شكل واحد ثوري فقط من أشكال النضال المتنوعة، إنما يشكل خطيئة كبرى في مجرى العملية النضالية فمن بين أبرز الأخطاء – الدروس التي بلورتها التجربة السابقة ضرورة المزج على نحو خلاق بين مختلف أشكال النضال وعدم الوقوع في خطأ تغليب الواحد منها على الآخر أو استبدال شكل بآخر، بحيث لا نُغَلّبُ عضلاتنا الغضة على عقولنا التي يجب أن تبقى حاضرة في الواقع ومعه، كما ذهب للقول د. جورج حبش في سياق نقده للتجربة النضالية التاريخية والراهنة الممتدة والذي هو أحد أبرز مؤسسيها.
لقد برز في سياق تجربتنا الفلسطينية عمومًا، على مدى صراعنا الطويل مع العدو الصهيوني اتجاه يحاول إلغاء أو حذف أو التقليل من قيمة شكل نضالي لحساب أشكال أخرى، بما يتوافق مع فهمه الخاص أو مصالحه الخاصة بمعنى أدق، وهذا ما لم يزكه الواقع، في دلالة على حيوية وديناميكية وثورية الشعب الفلسطيني، في مقابل تدني مستوى قياداته وأداء أحزابه ومؤسساته الوطنية الخاضعة لهيمنة وتفرد هذه القيادات، وهنا يبرز دور الشرط التاريخي الراهن والعاجل في تجاوز هذا الواقع/الفجوة بين مستوى كفاحية الشعب القصوى، وتدني مستواها لدى أغلب قياداته حد العجز والهبوط المريع أو الاستسلام الكارثي. وعليه؛ فإن بناء “الكتلة التاريخية” النقيضة لهذا الواقع/الفجوة، تحتاج لحزبها الثوري المتقدم للصفوف، والذي بات مهمة راهنة وعاجلة، باعتبار ذلك ضرورة لا ترف، رغم كل ما يمكن أن يقال من نقد موضوعي صادق لتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية بقواها كافة، إلا أن الحاجة للحزب الثوري في فلسطين على طريق بناء “الكتلة التاريخية”؛ يفوق في ضرورة وجوده أي مكان آخر، وذلك ارتباطًا بطبيعة الصراع الشامل والتاريخي مع العدو الصهيوني، الذي يواجهنا بأعلى درجة من التنظيم والتخطيط والكفاءة في إطار مشروعه/أهدافه المُحكمة، وبأقصى فعالية ممكنة؛ فهذا التنظيم والتخطيط هو الذي جعل إمكانية توظيف وصهر “المُجمع الاستيطاني الصهيوني” القادم من مئة دولة، في خدمة المشروع الإمبريالي، ومواجهتنا بكامل طاقته.
فالحزب الثوري بالمفهوم العلمي الصحيح هو نقيض للعفوية والارتجال والعشوائية التي تسود في حالتنا؛ كونه وسيلة/أداة تنظيم وتخطيط وتثقيف وتوجيه وارشاد وتعبئة وتوحيد للجماهير وحشد للطاقات وجذب للكفاءات وتجديد وخلق وإبداع… وقيادة وفعل؛ فضرورته كشرط تاريخي موضوعي تنبع أولًا من اسمه ووظيفته؛ التنظيم/العامل الذاتي/الأداة /الحزب. وثانيًا، أنه مدخل ممارسة العمل السياسي. وثالثًا، العامل الذاتي المُستغرق في وعي الواقع الموضوعي وشروطه، قراءةً وتشخيصًا وتحديدًا للرؤية والأهداف والخطط والبرامج ووسائل النضال. ورابعًا، أداة تثقيف وتوجيه وقيادة. وخامسًا، الحزب الثوري… فاعل التغيير الرئيسي على طريق بلوغ الأهداف الوطنية. وعليه؛ يغدو الحزب هو محفز الشرعية الكفاحية الشعبية التي لن تخطئ طريقها، وشرط المسير نحو جبهة الشعب الموحدة وحربها طويلة الأمد، وبالتالي تكتمل فصول الاشتباك مع العدو في كل زاوية ونقطة وقضية من زوايا ونقاط وقضايا الصراع التاريخي.
إدامة الاشتباك لا فضه
إن الثورة في المآل النهائي من صنع الجماهير؛ نتاج عمل دؤوب ومتواصل يقوم به حزب/جبهة “الكتلة التاريخية” من أجل تحقيقها؛ فهو عمل بين الجماهير ولأجلها، فإذا كان العمل الثوري يحتاج إلى “الغرف المغلقة” أو العمل السري، فإن حاجتها الأساسية في العمل بين الجماهير، تحريضًا وتعليمًا على فنون وأشكال النضال السياسية والعسكرية والتنموية والاجتماعية والديمقراطية… والارتقاء بوعيها، وبالتحديد الواضح لأهدافها، وتعزيز عملية الحراك الثوري بدفع عمليته الصاعدة إلى الأمام من على قاعدة توحيدها وقيادتها. إن تقريب المسافة بين الأقوال والأفعال، بين الخطاب والممارسة، بين النظرية والتطبيق، هو الذي يؤدي لاستعادة الدور المطلوب وشروطه التاريخية في استنهاض وتوحيد الحالة الشعبية التي هي مصدر الشرعية الوحيدة لأي عملية نضالية تَدَرُجية/تركيمية، حيث نجاحها يعتمد على القدرة والفعالية والتماسك الداخلي ووضوح الاستراتيجيات والتكتيكات والبرامج والسياسات وترجماتها العملية والممارسة الديمقراطية والاستجابة الفاعلة لمصالح واحتياجات الجماهير دون تقاعس أو تأخير. “ولعل أبرز ما يميز هذه اللحظة عن باقي اللحظات الثورية السابقة، أنها تأتي في مرحلةٍ تشهد انحطاطًا ووهنًا على كافة الأصعدة: الوطنية والعربية والعالمية، وتشهد سخطًا شعبيًا كامنًا وظاهرًا على حالة التردي والعجز والضعف الذي تشهده الساحة الفلسطينية، أي أنها تأتي نتاجًا لحالة الضعف السائدة، ولا ترتكز على أيةِ قواعد صلبة ومتماسكة وتستمد حيويتها وتناميها من حالة الجمود الراهنة، أي أن عوامل قوتها كامنة في ضعفها”.[9]
“إنه زمن الاشتباك” الذي صاغه غسان كنفاني قبل ستون عامًا في جل رواياته وكتاباته الأدبية والسياسية والنقدية منها، في قراءته لواقع الحالة الوطنية في “ذروة” صعودها، بعد الهزيمة/النكسة؛ فمن مرارة اللجوء الفلسطيني، والالتحام الدائم مع الفقر والجوع والتشرد والمعاناة؛ الوجه الآخر لحرب صمتت مدافعها، وبدأ مقاتلوها صراعًا محمومًا مع القهر والظلم والانكسار والهزيمة، وأعجوبة المرور اللحظي “بين طلقتين” والنجاة، حيث الفضيلة الأولى في ذاك الزمن هي “البقاء حيًّا”، والتي بقيت نبوءته الثورية مستمرة إلى يومنا هذا مع المثقف المشتبك باسل الأعرج الذي عرف أجوبته، متسائلًا: “هل هناك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد؟!”؛ مرورًا بالمقدام إبراهيم النابلسي الذي أوصانا: “حافظوا على الوطن من بعدي”، وليس انتهاءً بشجاعة عدي التميمي وقوله البليغ: “أعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها، واضعًا هدفًا أساسيًا أن ثمرة العملية؛ مئات من الشباب ليحملوا البندقية من بعدي”. وإذا ما راجعنا وصايا أغلب الشهداء الذين ترجلوا من كتيبة جنين إلى عرين الأسود ومن سبقهم، سنجدها جميعًا؛ تحفزنا لأن نديم الاشتباك لا أن نفضه؛ فاستمرار الاشتباك هو المعادل الموضوعي لوجود الاحتلال، ولتحرر وانعتاق الأمة العربية وليس الشعب الفلسطيني وحسب.
[1]. كميل أبو حنيش: على صفيح ساخن: اشتباك تاريخي مفتوح (الحلقة الثانية)، بوابة الهدف الإخبارية، 22 أكتوبر 2022: https://hadfnews.ps/post/107806
[2]. عبد الوهاب المسيري: الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ، دار الشروق، مصر، ط.1، 1997، ص 132.
[3]. خالد صافي: دراسات نقدية في التاريخ الفلسطيني المعاصر، مكتبة الصيرفي للنشر والتوزيع، فلسطين، 2020، ص 247.
[4]. شلومو ساند: اختراع الشعب اليهودي، ترجمة: سعيد عياش، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، رام الله، ط.2، 2013، ص 13.
[5]. إبراهيم أبراش: المشروع الوطني الفلسطيني: التباسات التأسيس وتحديات التطبيق، مجلة سياسات، العدد 8، ربيع 2009، ص33.
[6]. وسام الفقعاوي: نحن والعدو وميزان القوى المختل، مجلة الهدف، العدد 31 رقميًا (1505) بالتسلسل العام، فلسطين، نوفمبر/تشرين أول 2021، ص 26.
[7]. معالجة ماركسية لبعض قضايا حركة التحرر الوطني: د.ت، ص 70.
[8]. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : نحو رؤية سياسية جديدة للمرحلة، المؤتمر الوطني السادس، تموز 2000، ص 89.
[9]. كميل أبو حنيش: على صفيح ساخن، مرجع سبق ذكره.